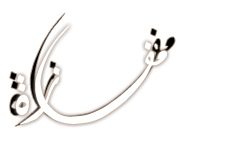قد تطل من نافذة عمارتك لترى في المواقف شجارا بين رجلين. بعد دقائق، يدخل أحد زملاء شقتك لتسأله عن الذي حدث فيقول لك “الرجل ذو القميص الأحمر ارتطم كتفه بكتف ذو القميص الأبيض، فلكمه هذا وبدأت مشاجرة بينهما”. بعد دقائق أخرى، يدخل الزميل الثالث فتسأله عن الذي حدث فيجيبك إجابة أخرى “أن الرجل ذو القميص الأحمر مروج مخدرات جاء ليبيع بضاعته على زبونه ذو القميص الأبيض، فأبى هذا أن يدفع كامل المبلغ، فنشب بينهما خلاف أدى الى الشجار”. ما هي القصة الصحيحة؟ قد تكون إحداهما، ولو كان لك زميل شقة ثالث، لربما كانت هناك ثلاث قصص حول الحدث نفسه.
قد يكون المثال السابق رديئا، لكني أعتقد أنه كافي لتوصيل الفكرة التي أريدها: فما تسمعه ليس بالضرورة هو حقيقة ما تراه. والمؤرخون يفرقون دوما بين “الوثيقة” و “القصة المحكية” حول هذه الوثيقة. فمثلا، هناك قرية في الصحراء، هذا القرية أثرية، فهي كلها تمثل وثيقة عن الماضي. لكن درج رعاة الإبل الذين يمرون من هذه القرية على سرد قصة لها، قصة مفادها أنهم أهلكوا بإعصار شديد. دور المؤرخ أن يقوم بالنقد، والنقد هنا يعني إعادة كشف العلاقات بين القصة المحكية حول الوثيقة والوثيقة نفسها للتأكد من صحة هذه القصة أو نقضها. بعد أن بحثت في القرية، وجدت اعلانات كثيرة على جدران عن أن كاهن القرية حدد يوما للانتحار الجماعي وقام به كل اهالي القرية الذين وجدت رفاتهم في مكان ما، بالاضافة للسجل الجوي لهذه المنطقة الذي يبين أنه لم يكن هناك إعصار في تلك الفترة… كل هذه الأدلة والقرائن تتعاضد على نقض القصة السابقة للوثيقة من أجل أن تحل محلها قصة جديدة يعتقد المؤرخ أنها الأقرب لواقع الوثيقة وحقيقتها.
عملية النقد هذه، قبل أن تبدأ، وقبل أن تكون ممكنة، تشترط قدرة ذهنية على التمييز بين الحدث والقصة المرافقة له.
تجمع المصريين في ميدان التحرير رافعين مطالبات محددة، هذا هو الحدث. هناك قصتين: قصة الجزيرة: هؤلاء ثوار سأمو من الظلم فقرروا إسقاط دكتاتورهم. قصة القناة المصرية: هؤلاء مخربين ومجرمين يريدون بث الرعب واحراق المباني.
بدل التسليم لأي من القصتين، على الشخص الذي يحترم عقله واستقلاليته أن يقوم بعملية نقد لهذه القصص عبر مطابقتها بالحدث نفسه، عبر التفكير بمدى منطقيتها، وكذلك ربطها بمصالح السارد نفسه. فهل توجد مصلحة للحكومة المصرية من تشويه سمعة المتظاهرين؟ وهل توجد مصلحة للجزيرة من تلميع صورتهم؟…إلخ هذه الأسئلة.
قد يعتقد البعض أنه بمجرد كوننا نعيش في عصر الصورة والنقل الحيّ من مكان الحدث، أننا بتنا نرى الحقيقة مباشرة، هذا ليس صحيحا، فكل سرد للحدث هو ادماج لقصة فيه، ولا بد أن نكون حذرين في قبولنا لهذه القصص، ونقديين بالتعامل معها، خصوصا إذا كان مصدر هذه القصص حكومات مستبدة لا توجد لديها أي مصلحها في ابراز الحقيقة.
تقول حنة أرندت: “إذا كانت الفلسفة الغربية قد خلصت إلى أن الواقع هو الحقيقة- وهذا طبعا هو الأساس الأنطولوجي لأطروحة تطابق الفكر مع الواقع- فإن النزعة الشمولية قد استنتجت من ذلك أنه بامكاننا أن نصطنع الحقيقة طالما كان بإمكاننا اصطناع الواقع؛ الأمر الذي لا يجعلنا ننتظر الواقع حتى يكشف عن نفسه مبينا لنا وجهه الحقيقي، بل يمكّننا أن نخرج للوجود واقعا بمكونات معروفة لدينا منذ البداية… لأن الأمر كله من انتاجنا أصلا”.