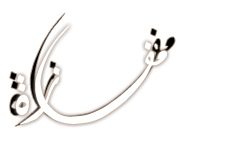-١-
تلخص حنة أرندت الدافع الذي من أجله قام هيرودوتس- (أبو التاريخ) كما يسميه شيشرو- بكتابة تاريخ “الحروب الفارسية” بأنه أراد أن (يحتفظ بما يدين بوجوده للناس، خشية أن يتم طمسه من قبل الزمان، وليسبغ على الأفعال المجيدة والجميلة التي قام بها كل من الإغريق والبربر ما يليق بها من الإنعام، حتى تضمن تذكرها من قبل الأجيال القادمة وليصبح مجدهم مشعا عبر الأجيال) (Between Past and Future, 41).
على العكس من المؤرخ الحديث، كان المؤرخ القديم يرى دوره محصورا بتخليد الأعمال العظيمة، الأعمال التي لا تستطيع بنفسها الخلود، لكنها دوما بحاجة إلى المؤرخ أو الشاعر لتخليدها، وذلك عبر إدماجها في (الذاكرة). كيف يمكن أن تخلد لنا مقولة عظيمة كمقولة عمر بن الخطاب (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟) لو لم يكن هناك مؤرخين وجدوا أن من صميم عملهم إدراجها في الذاكرة.
إن من طبيعة أقوالنا وأفعالنا أنها زائلة. تمحي من الوجود بمجرد أن ننطق بالكلمة أو نقوم بالفعل. فهي ليست باقية كالجبال مثلا، التي يولد أحدنا ويموت وهي راسخة في مكانها لا يتمكن منها الزمان. أقوالنا وأفعالنا، لا تستطيع حتى أن تبقى مثلما تبقى (صناعاتنا)، أي تلك الأشياء التي نقوم بصناعتها من مواد أولية مأخوذة من الطبيعة. فالتماثيل واللوحات العظيمة استطاعت مقاومة الزمان، وبقيت- على الرغم من أن صانعيها زالوا من الوجود- فترات طويلة تظاهي في بقائها بقاء الجبال، وما هذا إلا لأنها مصنوعة من الطبيعة الباقية. لكن وحدها أقوالنا وأفعالنا هي التي تزول بمجرد أن نقولها أو نفعلها، ولا يخلدها إلا الاحتفاظ بها في مستودع الذاكرة.
-2-
تنقسم فعاليات الإنسان التي تحدد وجوده إلى ثلاث أعمال: كدح، وصناعة، وعمل. فالكدح هو كل الأعمال التي نقوم بها من أجل سد حاجاتنا البيولوجية، من أجل إطعام أنفسنا وإبقاء دورة الحياة فينا تتم عملها. أما الصناعة فهي ذلك العمل الذي نقوم من خلاله بنزع الطبيعة عن الأشياء عبر تحويلها إلى أشياء أخرى تشكل عالمنا الذي نعيش به. إنها الفعالية التي نبني من خلالها المنزل والشارع والسيارة وكل ما يشكل عالمنا الذي نعيش فيه. إن ما تهدف إليه عملية الصنع هو إنتاج منتج يدوم. منتج يتحول إلى جزء من عالمنا ليدوم بيننا أكثر بكثير من حياة من قاموا بصناعته أنفسهم، وهذا المنتج يتشكل في اللحظة التي تنتهي فيها عملية الصنع ليبدأ ديمومته الخاصة مستقلا عن (زائلية) صانعيه. أما النوع الثالث وهو العمل فهو يشترط وجود الآخرين، إنه ما نسمعه ونراه من أقوال وأعمال وما نريد قوله وإسماعه الآخرين، أنه أكثر الأشياء زوالا وينتهي بمجرد القيام به، وبدون آخرين يسمعونه ويرونه يكون كما لم يكن.
ولأن الكدح مرتبط بشكل جوهري بحاجاتنا الجسدية، فهو يعتبر نشاطا منحطا، لأن الإنسان يقوم به مدفوعا بحاجاته الجسدية. وكذلك الصناعة وإن بدت أنها منبع المنتجات العظيمة- مباني جميلة، تماثيل فاتنة، إختراعات هائلة- إلا أنه في حد ذاته نشاط مشروط بغايته. كل ما نقوم به في الصناعة هو محاولة لوصول لغاية محددة- بناء منزل مثلا- وبالتالي يكون كل نشاطنا محصورا بالتفتيش بين الوسائل الممكنة التي تمكننا من تحقيق هذه الغاية؛ وهو من هذه الزاوية منحط أيضا، لأنه مرهون بغاياته، التي هي أشياء مفصولة عنه. ولكن وحده العمل الذي يعني الحرية. أن تعمل- تقول أرندت: (أن تبادر، أن تبدأ… أن تضع شيئا في حركة). العمل هنا غاية في حد ذاته، لا يهدف إلى شيء أكثر من الظهور أمام الآخرين وبدء شيء جديد بينهم.
ولتوضيح الفرق بين (الصنع) و (العمل)، أستعير من أرندت مثال: الرسام والراقص. فالرسام عندما يقوم بالرسم يختفي بعيدا عن الناس. ولا يعمل بحرية أبدا، نظرا إلى أن ما يريد أن يراه على لوحته هو: غاية، كان قد حققها مسبقا في رأسه، بدأت تملي عليه كافة الوسائل التي عليه اتخاذها من أجل أن يحققها. وبمجرد أن ينتهي عمله، بمجرد أن ينجز لوحته، يأخذها ليعرضها أمام الناس، فما يعرضه الرسام أمام الناس هو (منتج) صنعه، لا (صنعه) نفسه. بالمقابل، فإن الراقص يعرض رقصته نفسها، التي تنتهي بتوقفه عن الرقص، فما يقوم بعرضه أمام الآخرين ليس منتجه بل (عمله) نفسه.
وأهم ما يميز العمل عن الصنع، والذي به ينال العمل مكانته السامية باعتباره جوهر حرية الإنسان، أن الإنسان عندما يهم بالعمل لا يعلم تماما ماذا سيعمل ولا يعلم أبدا ماذا سيتولد عن عمله، إنها نوع من (المعجزة)، نوع من الانفصال عمّا قبل وعما لم يأت بعد، مثل العربي القديم الذي لا يجد في إلقاءه للقصيدة – بحسب الجاحظ- (مكابدة ولا إحالة فكرة ولا استعانة، وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام أو حين يمتح على رأس بئر، أو يحد ويعير، أو عند المقارعة والمناقلة، أو عقد صراخ أو في حرب. فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني أرسالا، وتنثال عليه الألفاظ انتثالا…) (البيان والتبيين، ج ٣ ص ٣٨). أن تعمل يعني أنك حر، يعني أنك تبدأ شيئا جديدا لا علاقة له بما قبل، شيء لا يمكن فهمه بربطه ربطا (عليّا) بما سبق. بالمقابل، الصناعة هي وسائل لغايات محددة مسبقا، كل ما يتم القيام به أثناء الصناعة، محكوم بـ(الضرورة)، ضرورة الوصول إلى هذه الغايات التي محددة مسبقا.
-٣-
كان البوعزيزي كادحا، لا صانعا ولا عاملا. كان يبيع الخضار، من أجل أن يجد قوت يومه، ويعيش حياته داخل دورة من الحياة البيولوجية مرتبطة بحاجات الحياة الأساسية من سد جوع وغيره، كان يكدح لكي يستمر بالحياة فقط. بالمقابل، كان ستيف جوبز صانعا، أو مخترعا كما نقول في أيامنا هذه، وبمجرد (صناعته) للحاسوب الشخصي، تحول إلى رجل أعمال ينتقل من نجاح إلى نجاح في إدارة الشركات.
في الوقت الذي كان يزداد البوعزيزي فقرا، كان جوبز يزداد ثراء ويعود لشركة أبل التي كانت على حافة الإنهيار، فيقيم صلبها من جديد منتجة منتجاتها العظيمة كالآي فون والآي باد وغيرها. دورة الحياة البيولوجية تحيط بعنق البوعزيزي وتخنقه، بينما يعيش جوبز في سلسلة من النجاحات التي هي تحقيق غايات جديدة عبر توظيف وسائل متنوعة. فعالم التجارة، هو عالم التخطيط والاستفادة من إنعدام (العمل) الذي حل محله (السلوك) في مجتمع المستهلكين الذي كانت قدرته الاستهلاكية هي قرن الثور الذي يخشى عالم التجارة اهتزازه فينهار بأكمله.
لو أن البوعزيزي عندما صودرت عربته خضع وحاول التفتيش عن طريقة أخرى يكدح من خلالها، لما كان بالإمكان مقارنته بجوبز، بل لعلنا لم نكن قد سمعنا باسمه حتى الآن. لكن عوضا عن ذلك، قرر أن يقوم بـ (عمل)، أن يحرق نفسه أمام الناس. وهذا الانتقال وحده من (الكدح) إلى (العمل)، هو الذي سيحفظ اسمه خالدا خلود الجبال الراسخات. فما فعله بعود ثقابه الذي أشعل به جسده: عمل عظيم، لكنه أيضا زائل، ينتهي بمجرد أن تخمد النيران في جسده. لكن عظمة فعله التي ثقبت الزمان، كان بالإمكان أن يتم سدها، لولا أن عشيرته (عملت) لتزيد سعة فتحة الزمان اتساعا للمرحلة التي انفصل فيها الماضي عن المستقبل الذي بات الآن رهينا لأعمال الناس، لبداياتهم، لحريتهم التي ابتدأها البوعزيزي.
لو أن البوعزيزي لم يفعل ذلك، لما كان أحد العظماء الذي بعمل واحد قضى نحبه بعده، قام بما لم يستطع ستيف جوبز أن يفعله، إذ أن هذا الأخير ظل طول حياته رهينة لغاياته التي حددت أفعاله كصانع. مات البوعزيزي حرّا، في دولة مستبدة، في حين أن جوبز مات عبدا لغاياته في دولة يقال لنا أنها حرة.